الله والعلم والبراهين بعيون عربية… قراءة في كتاب “الله” للعقاد
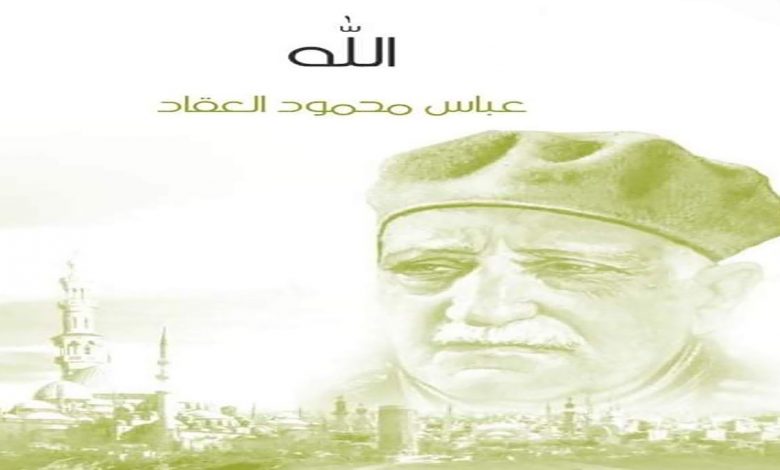
د. منتصر الوكيلي
كنت قد كتبت مقالا منذ أسابيع حول كتاب حديث الصدور في فرنسا يحمل عنوان “الإله والعلم والأدلة” لكاتبين فرنسيين هما ميشيل إيف بولوريه واوليفيه بوناسييس، ولم ألبث أن طرحت على نفسي أسئلة من قبيل: لماذا يوحي الكتاب بأنه تطرق لموضوع لم يسبقه إليه أحد؟ وهو علاقة ” الذات الإلهية” بالعلم، ومدى نفي هذا الأخير للخلق أو اعترافه به. وهل كتب أحد من العرب في الموضوع من قبل؟ وسافرت ذاكرتي إلى مقدمة ابن خلدون وعرجت على ابن سينا وابن طفيل وابن رشد والغزالي قبل أن تستقر في القرن العشرين على كتابات محمد عابد الجابري ومحمد أركون….
بيد أن شعاعا بعيدا قادني إلى عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد الذي خصص كتابا كاملا عن موضوع الذات الإلهية أسماه بكل بساطة “الله”، وكنت أجده مع مجموعة من كتبه وقد أعيد طبعها حديثا لدى باعة الكتب، وحتى سعرها لا يتعدي الدراهم المعدودة مع الصورة المعروفة للعقاد بغطاء رأسه يقيه البرد والنزلات الحادة.
وحيث إن الرابط بين الكتابين هو موضوع العلم في علاقته بالذات الإلهية وإن تفرقت بهما سبل التحليل والاستقراء، إلا أني وجدت في الكتاب العربي ضالة لم يوفرها النص الفرنسي، فقد كان العقاد موسوعيا و”منصفا” ولا أقول موضوعيا… ولا أعتقده يزعم ذلك.
فمن خلال ما يزيد على عشرين فصلا، انطلق العقاد في تتبع مراحل ظهور العقيدة الإلهية في الوعي البشري، بدءا من عبادة البشر للأسلاف والطواطم إلى عبادة الآلهة، أو فلنقل إلى تأليه الأسلاف المعبودين. فبعد أن عبد المخلوق الآلهة وقدسها وصنع لها قصصا وأساطير، ظهر التوحيد الخالص الذي هو الهدف السامي وراء الخالق.
لقد تجول الكاتب في التاريخ والفلسفة والبراهين العلمية على السواء، فتطرق إلى أصل العقيدة، ثم أطوار العقيدة الإلهية، والوعي الكوني، وتتبع مسار العقيدة في كل من مصر والهند والصين واليابان وفارس وبابل واليونان، مقارنا بين بعض فصول كتاب الموتى المصري والمزامير النورانية، مشيرا إلى أسبقية التوحيد عند المصريين، محللا نحلة كونفوشيوس وبودا وزرادشت، قبل أن يتوقف أمام مرحلة جديدة في الدين مثلتها اليهودية والمسيحية والإسلام، تناول بعدها بالتحليل الفلسفة ودورها في التأثير على الأديان، فناقش الفلسفة بعد الأديان الكتابية، وخصص فصلا عن التصوف، وتناول براهين وجود الله بما في ذلك البراهين القرآنية وآراء الفلاسفة المعاصرين في الحقيقة الإلهية والعلوم الطبيعية والمباحث الإلهية، وفي ختام المطاف لم يفت العقاد أن ينبه إلى أن الله الخالق حمل الإنسان عبر العصور إلى معرفته بفضل البديهة التي غرسها فيه.
” ومن أجمل ما استوقفني في الكتاب رأي العقاد في أراء علماء الطبيعة: “….إن العلـوم الطبيعية نفسهـا فليس من شأنـها أن تخوِّل أصحابها حق القول الفصـل في المبـاحث الإلهيـة والمسـائل الأبديـة، لأنها من جهة مقصـورة على ما يقبـل المشاهدة والتجربة والتسجيـل، ومن جهة أخرى مقصورة على نوع واحد من الموجودات ، وهي بعد هذا وذاك تتناول عوارض الموجودات ، ولا تتنـاول جوهر الوجود ، وهو لا يدخل في تجارب علم من تلك العلـوم ” .
وفي “خـاتمة المطاف” كتب الأديب العربي : “وخاتمة المطاف أن الحس والعقل والوعي والبديـهة تستقيـم على سواء الخلق حين تستقيم على الإيـمان بالذات الإلهيـة ، وأن هذا الإيـمان الرشيـد هو خير تفسيـر لسر الخليقـة يعقله المؤمن ويدين به الفكر ويتطلبـه الطبع السـليم “..
لا يمكن عقد مقارنة بين كتاب صدر في أوائل القرن الماضي وآخر في بدايات القرن الحالي وبلغتين مختلفتين، لكن القارئ سيجد في كتاب العقاد متعة اكتشاف واستكشاف لا تملؤها الألغام ولا تسيطر عليها الأوهام، وذلك أضعف الإيمان.











