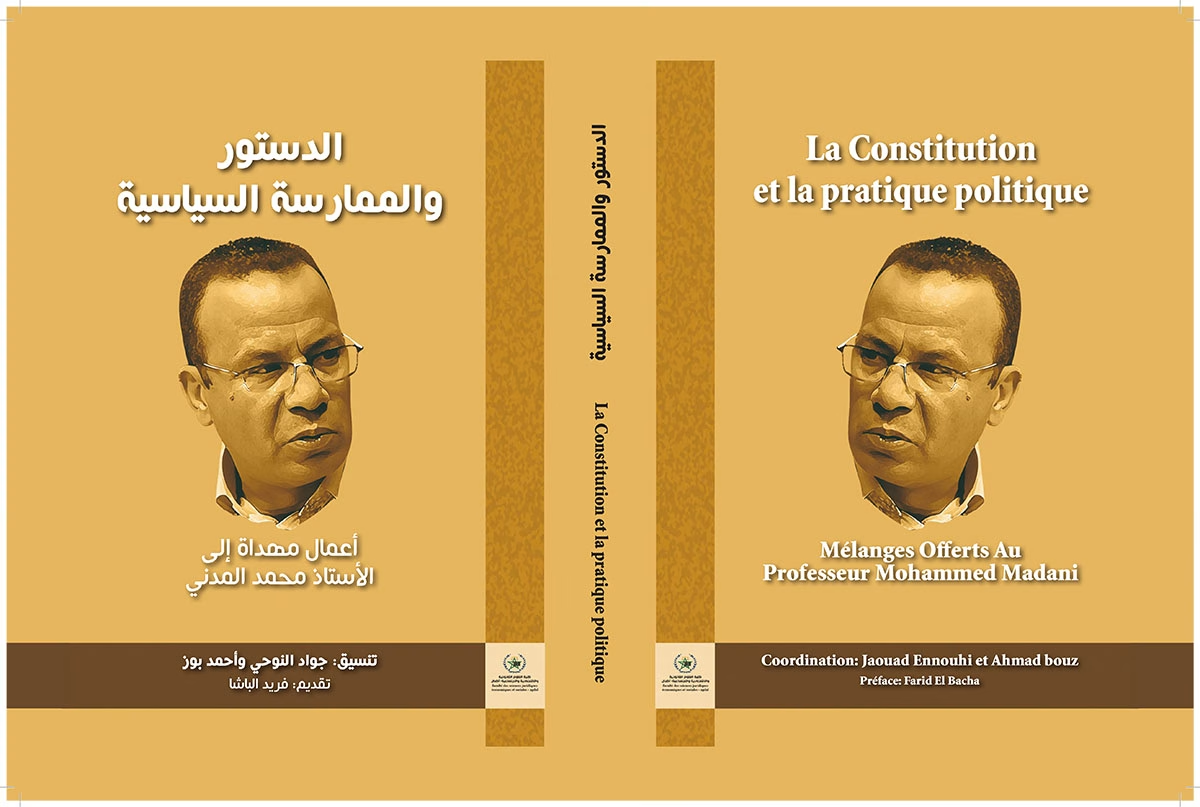
يُعدّ كتاب “الدستور والممارسة السياسية”، المُهدى للأستاذ محمد مدني، مرجعًا قانونيًا وسياسيًا هامًا يتناول تطور الدستور المغربي وتأثيره على الممارسة السياسية، مع التركيز على التحولات الديمقراطية والتحديات المرتبطة بالحقوق والحريات، العلاقة بالقانون الدولي، والمبادرات الإصلاحية مثل الدولة الاجتماعية ومبادرة الحكم الذاتي.
يسلط الكتاب الضوء على إسهامات الأستاذ مدني في دراسة الإصلاح الدستوري، مع تحليل نقدي لتجربة الدستور المغربي، خاصة إصلاح 2011، والذي شكل نقطة تحول رئيسية في المسار الدستوري للمملكة.
تطور الدستور المغربي: من المطالب الإصلاحية إلى دستور 2011
يعود التفكير الدستوري في المغرب إلى مطلع القرن العشرين، حيث شهد عام 1908 أول مشروع دستوري نشرته جريدة لسان المغرب، تضمن مفاهيم حديثة مثل “الدولة“، “المواطنة“، و”المساواة أمام القانون“. ومع بروز الحركة الوطنية في ثلاثينيات القرن الماضي، أصبحت المطالبة بالإصلاح الدستوري محورًا أساسيًا، كما تجلى في “مخطط الإصلاحات” عام 1934، الذي اعتمد نهجًا قانونيًا وسلميًا لتحقيق التغيير. بعد الاستقلال عام 1956، اعتمد المغرب نموذجًا ليبراليًا في دستور 1962، لكنه وُصف بـ”الليبرالية السياسية الشكلية” بسبب محدودية التطبيق العملي.
شكّل دستور 2011، الذي أُطلق بعد خطاب 9 مارس 2011 الملكي في سياق “الربيع العربي“، محطة بارزة. تضمن الدستور مبادئ أساسية مثل فصل السلطات، تكريس دور الأحزاب السياسية في تشكيل الحكومة (المادة 47)، وضمان الحقوق والحريات الأساسية (المادتان 19 و25). كما عزز مكانة القانون الدولي، حيث نص الدستور في ديباجته ومادته 55 على أولوية المعاهدات الدولية المصادق عليها على التشريعات الداخلية، مع خضوعها للدستور و”ثوابت المملكة“.
نقد إصلاح 2011: “الآلية السياسية” وتداعياتها
رغم طموحاته، تعرض دستور 2011 لانتقادات حادة بسبب التعديلات التي أدخلتها “الآلية السياسية” على مشروع اللجنة الاستشارية. من أبرز هذه الانتقادات:
- تعديل الطابع الديني للدولة: أكد النص الرسمي (TOC) أن “الدولة مسلمة”، مما اعتُبر مشكلة قانونية، إذ ينبغي أن يقتصر الوصف الديني على الأفراد وليس الدولة، الأمر الذي سمح لأحزاب مثل العدالة والتنمية بإعاقة إصلاحات تقدمية.
- التمييز بين اللغتين الرسميتين: أقر النص الرسمي تسلسلًا هرميًا بين العربية والأمازيغية، على عكس مشروع اللجنة الذي أكد التمييز بين اللغتين الرسميتين: أقر النص الرسمي تسلسلًا هرميًا بين العربية والأمازيغية، على عكس مشروع اللجنة الذي أكد المساواة بينهما.
- المساواة بين الجنسين: ربطت المادة 19 المساواة بين الرجل والمرأة بـ”ثوابت المملكة”، مما اعتُبر خطأ قانونيًا جسيمًا، إذ يعلو القانون الداخلي (الذي قد يناقض المساواة، كقانون الإرث) على الدستور.
- الحريات الدينية: حذف النص الرسمي من المادة 3 التزام الدولة باحترام جميع المعتقدات وخضوعها لسيادة القانون، مما أضعف مبدأ حرية الاعتقاد.
تُظهر هذه التعديلات، التي وُصفت بـ”المتسرعة وغير المدروسة“، تأثير القوى المحافظة في إضعاف الطابع التقدمي للدستور، مما أثر على فعاليته في تعزيز الديمقراطية والحريات.
الحقوق والحريات: التكريس النظري والتحديات العملية
يكرس الدستور المغربي حقوقًا أساسية، مثل حرية الفكر والتعبير (المادة 25)، حرية الصحافة دون رقابة مسبقة (المادة 28)، والمساواة بين الجنسين (المادة 19). كما يحظر التعذيب (المادة 22) ويضمن الحق في الحياة وحرية الاعتقاد. غير أن التطبيق العملي لهذه الحقوق يواجه عقبات، لا سيما خلال حالة الطوارئ الصحية أثناء جائحة كوفيد-19، حيث فُرضت قيود على الحريات العامة (التجمع والتنظيم) بموجب بيانات وزارية دون الاستناد إلى الدستور، في خرق للمادة 70 التي تنظم التفويض التشريعي. كما استُخدمت هذه الفترة لاستهداف ناشطين وصحفيين، مما أثار انتقادات حول انتهاكات الحريات المدنية.
القانون الدولي: تكريس متزايد وتحديات التطبيق
يعزز دستور 2011 مكانة القانون الدولي في النظام القانوني الداخلي، حيث تتمتع المعاهدات المصادق عليها بأولوية على التشريعات الداخلية (المادة 55)، مع خضوعها للدستور. تُعدّ معاهدات حقوق الإنسان، مثل العهدين الدوليين لعام 1966 واتفاقية مناهضة التعذيب، مرجعًا أساسيًا لتفسير الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية. كما تُستخدم القواعد غير الملزمة (Soft Law)، مثل مبادئ باريس، كمرجع للتفسير القضائي. لكن التطبيق الفعلي للقانون الدولي يواجه تحديات، خاصة في ظل الفجوات التشريعية والتفسيرات المتباينة بين القضاء العادي والدستوري.
الدولة الاجتماعية: طموح ملكي وتحديات بنيوية
أطلق خطاب ملكي في يوليو 2020 مشروع الدولة الاجتماعية، بهدف تعميم التغطية الاجتماعية بحلول 2025، يشمل التأمين الصحي الإلزامي، التقاعد، والتعويض عن البطالة. يعتمد المشروع تمويلًا هجينًا (اشتراكات ودعم حكومي) بتكلفة 51 مليار درهم. لكن نجاحه يتطلب شروطًا غائبة جزئيًا، مثل:
- دولة القانون: يُصنف المغرب كـ”نظام هجين” بسبب ضعف استقلال القضاء، تقييد الحريات المدنية، ومحدودية نزاهة الانتخابات.
- سياسات اقتصادية داعمة: السياسات الليبرالية الحالية، المستندة إلى “إجماع واشنطن“، لا تدعم التمويل المستدام للدولة الاجتماعية، على عكس السياسات الكينزية التاريخية.
- تمويل مستدام: غياب إصلاح ضريبي تقدمي يحد من قدرة الدولة على توفير موارد كافية ومستدامة.
مبادرة الحكم الذاتي: توافق مع القانون الدولي
يُقدم الكتاب تحليلًا لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء (2007) كحل وسط يتماشى مع القانون الدولي، لا سيما مبدأ تقرير المصير الوارد في المادة 1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. تتيح المبادرة ممارسة التقرير الذاتي عبر الحكم الذاتي الداخلي، مع احترام الوحدة الوطنية والتكامل الترابي، وتضمن حقوق الإنسان المعترف بها عالميًا. وتتوافق مع قرارات الأمم المتحدة، مع خطط لإدراجها في الدستور في حال اعتمادها.
تحليل قانوني: بين الطموح الإصلاحي والمقاومات البنيوية
يكشف الكتاب عن تناقض جوهري في التجربة الدستورية المغربية: فمن جهة، يعكس دستور 2011 طموحًا ديمقراطيًا من خلال تكريس الحقوق، فصل السلطات، وتعزيز القانون الدولي؛ ومن جهة أخرى، تعيق المقاومات السياسية والثقافية، مثل تأثير “الآلية السياسية” وغياب دولة القانون الكاملة، تحقيق هذه الطموحات. كما تُظهر إدارة حالة الطوارئ الصحية هشاشة الالتزام بالشرعية الدستورية، بينما يواجه مشروع الدولة الاجتماعية تحديات بنيوية قد تحول دون استدامته.
ختاما يُبرز كتاب “الدستور والممارسة السياسية” تفاؤلًا حذرًا بإمكانيات الإصلاح الدستوري والسياسي في المغرب، لكنه يؤكد أن التحول نحو ديمقراطية حقيقية ودولة اجتماعية فعالة يتطلب إرادة سياسية قوية، إصلاحات ضريبية جريئة، وتعزيز دولة القانون.
وتبقى مبادرة الحكم الذاتي نموذجًا لتوفيق الالتزامات الدولية مع السيادة الوطنية، شريطة دعمها بإصلاحات داخلية شاملة.

قم بكتابة اول تعليق