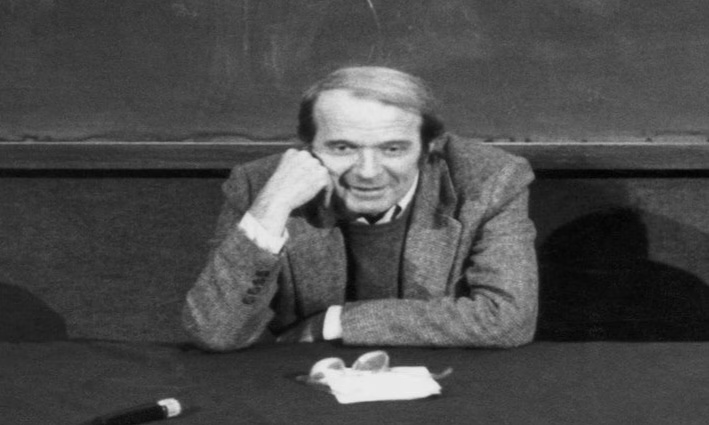
في تأملاته العميقة حول طبيعة الكتابة والفلسفة، يقدم جيل دولوز في كتابه “الأبجدية” رؤية ملهمة: “أنا لا أعرف ما إذا كنت أعتبر نفسي كاتبًا في الفلسفة، لكن ما أعرفه هو أن كل فيلسوف عظيم هو كاتب عظيم”. هذه العبارة ليست مجرد إشادة بالفلاسفة، بل دعوة إلى إعادة التفكير في العلاقة بين الكتابة والفكر، بين إبداع المفاهيم وتحويل اللغة. فالفيلسوف، كما الكاتب، مبدع يحفر في أعماق اللغة ليخلق شيئًا جديدًا، لكنه يفعل ذلك بطريقة تقوض الأنساق المعيارية وتفتح آفاقًا غير مسبوقة. كيف يمكننا فهم هذا التقاطع بين الكتابة والفلسفة؟ وما الذي يجعل من اللغة فضاءً للمقاومة والإبداع؟
يؤكد دولوز في كتابه “ألف بساط” أن الأدب هو “لغة داخل اللغة”، وهي أطروحة تستدعي التأمل في طبيعة الكتابة. الكتابة ليست مجرد نقل للأفكار، بل عملية تحويلية تعيد تشكيل اللغة ذاتها. الكاتب العظيم، سواء كان كافكا الذي يكتب بالألمانية رغم جذوره اليهودية-التشيكية، أو بيكيت الذي يتنقل بين الإنجليزية والفرنسية، لا يكتفي باستخدام اللغة كأداة، بل يُخضعها لعملية “تفكيك” و”إعادة بناء”. هؤلاء الكتاب يعيشون حالة من الازدواجية اللغوية، لكنها ليست مجرد تعايش بين لغات، بل صراع خلاق يُنتج لغة جديدة، لغة “صغرى” تتحدى الهيمنة المعيارية للغة “الكبرى”.
اللغة الصغرى*، كما يعرفها دولوز، ليست لغة منفصلة أو لهجة محلية، بل هي استخدام تحويلي للغة الأغلبية يُدخل إليها الفروق والانزياحات. فعلى سبيل المثال، ألمانية كافكا ليست مجرد ألمانية قياسية، بل لغة “مهجنة” تحمل في طياتها صوت الأقلية، صوت اليهودي في براغ، مما يجعلها لغة “غريبة” داخل اللغة. هذا التحويل ليس مجرد لعبة أسلوبية، بل فعل سياسي يُعبر عن “مقاومة جزيئية”، مقاومة لا تتحدى السلطة بشكل مباشر فحسب، بل تُفكك بنيتها من الداخل عبر خلق “صيرورات” جديدة في اللغة.
الصيرورة، وهي مفهوم مركزي عند دولوز، تُجسد دينامية الكتابة الأقلية. الكاتب لا يسعى إلى إعادة توطين اللغة في إطار محلي أو لهجي، بل إلى “إخراجها عن توطنها”، أي تحريرها من القيود المعيارية التي تفرضها السلطة. دولوز يقدم مثال الأمريكيين السود الذين لا يخلقون لغة منفصلة ضد الإنجليزية، بل يحولون الإنجليزية الأمريكية إلى “إنجليزية زنوج”، لغة تحمل صوت الأقلية وتُعبر عن تجربتها الفريدة. هذه الصيرورة لا تقتصر على تغيير الدلالات، بل تمتد إلى تفكيك الثنائيات (مثل الأغلبية/الأقلية) وإعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية والسياسية.
الكتابة، في هذا السياق، تصبح فعلًا ثوريًا. فالكاتب الأقلي، كما يراه دولوز، لا يكتفي بتحدي “أدب السادة”، بل يُحرر اللغة من النموذج الأغلبي الذي يتمثل في “الرجل الأبيض البالغ العاقل”. هذا النموذج، الذي يُشكل معيارًا للسلطة، يُواجه بـ”تأتأة” لغوية تُدخل الحركة والحياة إلى البنيات الجامدة. بورخيس، على سبيل المثال، يكتسح اللغة الإسبانية بتوليفات جديدة تُحولها إلى فضاء للتجريب والإبداع، مما يجعل من أدبه “أدبًا صغيرًا” بمعنى أنه يخلق معاييره الخاصة.
إذا كانت الكتابة تُبدع لغات صغرى، فإن الفلسفة، بحسب دولوز، تُبدع مفاهيمًا جديدة. لكن هذا الإبداع المفاهيمي لا ينفصل عن اللغة، بل يتطلب تحويلها. الفيلسوف العظيم، مثل الكاتب العظيم، يُخضع اللغة لعملية “اختلال” دائم، حيث لا تكون اللغة نظامًا متجانسًا، بل كيانًا حيًا يتغير باستمرار. عندما يبتكر الفيلسوف مفهومًا جديدًا، فإنه لا يكتفي بإضافة كلمة جديدة أو معنى اعتباطي، بل يُعيد تشكيل اللغة لتتمكن من حمل هذا المفهوم. على سبيل المثال، مفهوم “الصيرورة” عند دولوز نفسه لم يكن مجرد كلمة، بل تركيب لغوي وفكري يُعبر عن دينامية التغيير المستمر.
هذا التحويل اللغوي في الفلسفة ليس زخرفة، بل ضرورة. فالمفاهيم الجديدة تتطلب لغة جديدة، أو على الأقل إعادة صياغة اللغة القائمة. وهنا يلتقي الفيلسوف بالكاتب: كلاهما يعمل على “تأتأة” اللغة، أي إدخالها في حالة من عدم الاستقرار الخلاق. لكن هذا العمل لا ينبع من ذاتية الفيلسوف أو الكاتب، بل من “شخصيات مفاهيمية” تُشكل وكلاء الإفصاح. هذه الشخصيات، كما يراها دولوز، ليست مجرد تجسيد للذات، بل قوى فكرية تُنتج المعنى عبر حركة التفكير.
ما يميز رؤية دولوز هو البعد السياسي للكتابة والفلسفة. لكن هذه السياسة ليست التزامًا بالمعنى التقليدي، كالانحياز إلى تيار يساري أو يميني. الأغلبية، في نظر دولوز، ليست مسألة عددية، بل نموذج مجرد يُمثل السلطة والمعيارية. هي “لاأحد”، لأنها تُفرض كواقع تحليلي يُقيد الإمكانيات. في المقابل، الأقلية هي “صيرورة الجميع”، لأنها تُحرر الإمكانيات عبر الانحراف عن النموذج الأغلبي. الكتابة الأقلية، إذن، لا تُحل نموذجًا جديدًا محل القديم، بل تُبقي اللغة في حالة تحول دائم، مما يجعلها فعلًا مقاومًا بامتياز.
هذه المقاومة تتجلى في تفكيك “قواعد اللغة الأخلاقية”، التي تُشكل، كما يرى دولوز وفوكو، معقل السلطة. الأسلوب، في هذا السياق، ليس مجرد تقنية، بل “آلية التحويل المستمر” التي تُحرر اللغة والفكر من قيود النظام المعياري. سواء في الأدب أو الفلسفة، الإبداع يكمن في صنع شيء جديد من عناصر قديمة، في خلق “توليفات” تُحيي اللغة وتفتحها على ممكنات غير متوقعة.
من وجهة نظر فلسفية، يُقدم دولوز رؤية تُعيد تعريف العلاقة بين الفكر واللغة. الكتابة والفلسفة ليستا مجرد وسيلتين للتعبير، بل عمليتان إبداعيتان تُحرران الإنسان من قيود الأنساق المعيارية. ما يجعل الكاتب والفيلسوف “عظيمين” هو قدرتهما على خلق “لغة داخل اللغة”، لغة تتحدى السلطة وتُنتج صيرورات جديدة. هذه الصيرورات ليست مجرد تغيير في الأسلوب أو المفاهيم، بل تحول في طريقة تفكيرنا ووجودنا في العالم. الكتابة الأقلية، بمعناها العميق، هي دعوة إلى الانحراف عن المعيار، إلى أن نكون “غرباء” في لغتنا الخاصة، ليس لننفصل عنها، بل لنُحييها من جديد.
في نهاية المطاف، يُظهر دولوز أن الكتابة والفلسفة هما وجهان لعملية إبداعية واحدة: خلق الممكن في قلب المعطى. سواء كان الأمر يتعلق بإبداع لغة صغرى أو مفهوم جديد، فإن التحدي يكمن في تحويل اللغة من نظام جامد إلى فضاء حي ينبض بالصيرورة. الكاتب والفيلسوف، في هذا المعنى، ليسا مجرد صانعي نصوص أو أفكار، بل هما مبدعان يُحرران اللغة والفكر من قيود السلطة، مُعلنان ثورة هادئة تُغير العالم عبر كلماتهم. فهل يمكننا، كقراء ومفكرين، أن نتبنى هذا التحدي ونُصبح “أقليين” في لغتنا الخاصة؟
*مفهوم اللغة الصغرى (langue mineure) عند جيل دولوز، كما يظهر في أعماله مثل كافكا: نحو أدب أقلي (Kafka: Pour une littérature mineure) وألف بساط (Mille Plateaux) بالتعاون مع فيليكس غواتاري، هو مفهوم مركزي يتعلق بالاستخدام التحويلي والمقاوم للغة ضمن سياقات اجتماعية وسياسية. إنه ليس مجرد وصف للغة أو لهجة معينة، بل نهج إبداعي وثوري لتفكيك الهيمنة اللغوية والثقافية لـ”اللغة الكبرى” (langue majeure)، التي تُمثل المعيارية والسلطة. فيما يلي تفاصيل دقيقة حول مفهوم اللغة الصغرى:

قم بكتابة اول تعليق